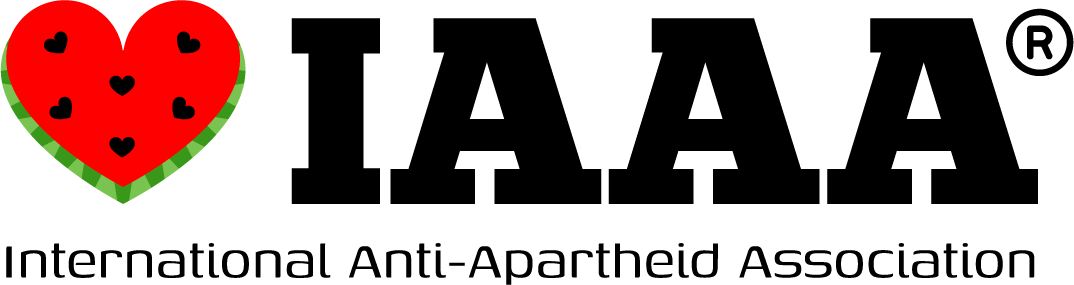نبذة مختصرة:
تسببت أربعة أعوام من تغوّل التحالف الأميركي – الإسرائيلي، بقيادة ترامب ونتنياهو، بخسارة شعبنا الفلسطيني كثيراً على الصعيد السياسي، وبمعاناة شديدة على الأرض، وخصوصاً في غزة والنقب ووادي الأردن والقدس، جرّاء القتل والتشريد والترهيب والحصار والنهب للأراضي والمياه وموارد الطاقة. ومن أخطر تجليات هذه الحقبة العصيبة انتشار الخيانة العلنية لقضية فلسطين من طرف أنظمة استبدادية عربية، وما رافق ذلك من اقتلاع متدرج – وأحياناً جذري – لحيّز فلسطين الخاص في الوجدان العربي، سواء من خلال حذف أو صهينة تاريخ فلسطين وحاضر قضيتها في مناهج الدراسة، أو تشويههما في الإعلام والفضائيات وتصريحات المسؤولين غير المنتخبين.
النص الكامل:
نحن شعب مثخن بالجراح، واحتمال شفائنا الذاتي ضئيل للغاية إن لم يكن معدوماً. فمعظم شعبنا اليوم يئن من خيانة الأنظمة من الخليج إلى المحيط، وربما بمقدار ألمه لفقدان الأرض والبيت. نتألم من صمت الأمم المتحدة، المهيمَن عليها غربياً، ومن تواطؤ “الديمقراطيات” التي كلما واجهت الخيار بين مصالحها وما يحمله تاريخها من خطايا من جهة، وحقوق الإنسان والقانون الدولي من جهة أُخرى، اختارت الأول من دون هوادة. كما نتألم من تهميش قضية فلسطين عربياً بسبب الانتفاضات الاجتماعية – الاقتصادية والنزاعات المسلحة والحروب، غير الأهلية، في العديد من الدول العربية الشقيقة.
ومع ذلك، لا يتعين على أحد أن يأخذ صورة فورية لهذا البؤس الفلسطيني كمؤشر إلى اليأس والهزيمة، فقد شُطبنا عدة مرات خلال تاريخ نضالنا – الذي يمتد إلى قرن من الزمن في محاربة الاستعمار الاستيطاني – لكننا كنا ننهض مرة أُخرى، وتقريباً من الرماد. وهذا ليس بسبب جيناتنا، وإنما لأن مقاومة الاضطهاد هي غريزة بشرية، بل ضرورة وجودية اليوم لأي شعب مضطهد يدافع عن بقائه وحقوقه، وخصوصاً إذا كان هناك أمل واقعي بنجاحه في إنهاء الاضطهاد.
لكن في ظل التطبيع الرسمي العربي المستشري، وفي صلبه التطبيع الرسمي الفلسطيني، هل يمكننا الحديث عن “أمل واقعي” بالنصر، أم إننا نكرّس رومانسية ثورية مجردة، لا صلة لها بالواقع؟
إن منبع أملنا وقوتنا اليوم لا يقتصر على عدالة قضيتنا فحسب، إذ لا قضية أكثر عدالة من قضية السكان الأصليين في أميركا الشمالية وفي كل مكان، ولا من قضية ملايين السود الذين لا يزالوا يعانون جرّاء قرون من العبودية والعنصرية الممنهجة، بل إن منبع أملنا الأهم اليوم يكمن أيضاً في فهمنا الأعمق والأكثر علمية وواقعية لمصادر قوتنا وقوة عدونا، وكذلك مصادر ضعفنا وضعفه، وقدرتنا على التأثير الحقيقي في عالم ليس لنا، مثلما يبدو، كي يصبح لنا ولجميع المضطهدين في الأرض مثلنا. لكن لا بد من التسليم بحقيقة أن ضعف عدونا لا يترجم تلقائياً إلى قوة لنا، لأن ضعفنا بات فاضحاً أكثر من أي وقت مضى مع صعود موجة التطبيع الرسمي، ومع ذلك لا بد من عرض أهم مكامن ضعف هذا العدو.
ففي ذروة قوته العسكرية والاقتصادية والتقنية، واتجاهه أكثر نحو الفاشية، أدمن نظام الاحتلال العسكري والاستعمار – الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، أن يكون القوة الغاشمة المنفلتة من عقالها تقريباً، كما أدمن الإفلات من العقاب، الأمر الذي أفقد المؤسسة الإسرائيلية كثيراً من بصيرتها الاستراتيجية وقدرتها التاريخية على خداع شعوب الأرض بواجهتها الديمقراطية “الحداثية” والتكنولوجية المتطورة، وبالترويج لنفسها كضرورة في “صراع الحضارات” ضد المشرق “الإسلامي المتخلف والعنيف”. ومثلما هو الوضع في كل إدمان، فإن هذا الأمر سيكلف إسرائيل غالياً، ولا سيما مع تضاؤل القوة الأميركية بالتدريج، وبداية تحوّل ميزان القوى العالمي – على الأقل اقتصادياً – من الغرب إلى الشرق، أو الشرق الأقصى على وجه الدقة.
فاليوم، على سبيل المثال، لم يعد اتهام إسرائيل باقتراف جريمة الأبارتهايد وجرائم الاستعمار – الاستيطاني وقتل الأبرياء وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من المحرمات في الاتجاه السائد، حتى في الغرب. كما أن عزلة إسرائيل على الصعيد الشعبي والمجتمع المدني الدولي، تتفاقم باطراد، أساساً بسبب نضال حركة المقاطعة (BDS) وشركائها، وتأييد الملايين لها حول العالم في أكبر النقابات العمالية والكنائس والجامعات وأوساط الفنانين / ات والأكاديميين / ات والحركات التي تنشد العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعرقية والجندرية والبيئية.
ومع اجتياح التغيير النيو – ليبرالي لإسرائيل، بالتوازي مع انتشار الفساد غير المسبوق، والسلطوية، والأصولية اليهودية، التي تنافس الوهابية الداعشية في الإرهاب الفكري، يتعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإسرائيلي لتفكك بنيوي متدرج، على الرغم من العناوين الساطعة في الإعلام المهيمن بشأن قوة الشيكل والقوة النووية والاستخباراتية وشعار “start-up nation” المثير للسخرية. فلا شك في أن إسرائيل تملك عناصر قوة هائلة في شتى المجالات، لكن هذه القوة باتت اليوم أكثر من قبل محتكرة من طرف 1% من النخبة الاقتصادية، بينما تزداد معاناة معظم المجتمع، أي المجتمع اليهودي – الإسرائيلي (فضلاً عن المواطنين الفلسطينيين الأصليين في الدولة)، جرّاء تزايد معدلات الفقر وتدنّي الخدمات الصحية والتعليمية وتفشي الإكراه الديني وروح الفاشية، وخصوصاً بين الشباب.
وأي صراع إقليمي ستشعله إسرائيل ربما يكلّفها أكثر كثيراً من هزيمتها العسكرية النسبية خلال عدوانها على لبنان في سنة 2006. فهي قد تفقد تماسكها الاستيطاني – الاستعماري الداخلي، وبالتالي الدافع إلى الدفاع عن المستعمرة، الأمر الذي سيؤدي إلى هجرة العقول (مثلما حذر الصحافي الأميركي الصهيوني توماس فريدمان ذات مرة)، وإلى فقدان أهم عنصر قوة وتأثير لإسرائيل في التجارة والعلاقات العالمية، وهو ميزتها التكنولوجية الأمنية والعسكرية التي تطورها من خلال التجارب على شعبنا وأرضنا.
إن عوامل الضعف المذكورة أعلاه وغيرها يشكلان السياق الضروري لفهم أهمية التطبيع العربي – الإسرائيلي اليوم كسلاح إسرائيلي فاعل لمواجهة حصار إسرائيل المتزايد عالمياً، حتى في أوساط الشباب اليهود في الولايات المتحدة!
فإسرائيل، ومن خلال اتفاقيات التطبيع والخيانة الأخيرة مع أنظمة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، تطمح إلى تحقيق مكاسب أمنية – عسكرية واقتصادية ودبلوماسية مباشرة، كما تسعى لتحقيق مكسب آخر لا يقل أهمية، وهو تقوية جدارها الحديدي في عقول كثير من أبناء المنطقة العربية.1 وبحسب معجم المعاني، هناك عدة معانٍ لفعل “طبّع”، وأكثرها صلة بموضوع هذه المقالة هو: طبّع المُهْر، أي علّمه الانقياد والمطاوعة.
في مقالته الشهيرة، “الجدار الحديدي”، الصادرة في سنة 1923، حاجج الزعيم الصهيوني اليميني زئيف جابوتنسكي بأن “الاستعمار اليهودي لفلسطين”، مثلما سمّاه، لا يمكن أن يترسخ من خلال اتفاق طوعي مع السكان الأصليين. فبحسب رأيه، “لا يمكن إلّا أن يكون للاستعمار هدف واحد فقط، وعرب فلسطين لا يمكن أن يقبلوا هذا الهدف. إنه يكمن في طبيعة الأشياء، وفي هذا الصدد بالذات لا يمكن تغيير الطبيعة.”
لذلك، كان حل جابوتنسكي لهذه المعضلة هو بناء جدار حديدي نفسي باستخدام القوة الهائلة والممنهجة ضد العرب الأصلانيين في فلسطين كي يفقدوا أي بصيص أمل بالانتصار على الاستعمار، ويسلّموا بأبدية وجود وهيمنة المستعمرين فيها. ويستنتج جابوتنسكي أنه عندئذ فقط “يمكن أن تنطلق المفاوضات لتحقيق السلام [مع العرب] على أساس حل وسط يقوم على قبول الحقائق بدلاً من الحقوق.”
منذ ذلك الحين وحتى الآن، ظل “الجدار الحديدي” بأشكاله، بما فيها الأسمنتي الحالي، في صميم الأيديولوجيا الصهيونية في سعيها الدؤوب لاستعمار عقولنا وكيّ وَعْينا باستحالة النصر وبضرورة قبول الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لفلسطين لا كقدر محتوم لا بد من تقبّله فحسب، بل كأمر طبيعي أساساً أيضاً.
إن أهم أهداف هذا الجدار التطبيعي، إذاً، تتلخص في خفض سقف توقعاتنا ومطالبنا بما يتلاءم مع مخططات العدو للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين التاريخية بأقل عدد من السكان الأصليين، العرب الفلسطينيين. وهذه استراتيجيا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي نفسه في العالم الجديد، على الرغم من الاختلاف بين الحالتين، وخصوصاً لناحية عدم قدرة إسرائيل في العصر الحديث على القيام بإبادة من الطراز القديم للسكان الأصليين، وهو ما حداها إلى اتّباع “الإبادة المتدحرجة” والبطيئة كبديل، مثلما يتجلى في مجازرها ضد شعبنا في قطاع غزة.
إن التطبيع إذاً في أبسط تعريف هو إظهار الشيء بصورة زائفة تخالف طبيعته، أو ترويض كائن ما ليتصرف عكس طبعه، وهذان الشكلان، التزييفي والترويضي، متلازمان في التطبيع المعاصر الذي استشرى في حقبة أوسلو. وكي تكون مناهضة التطبيع فاعلة ومقنعة، فإنها يجب أن تجمع بين المبدئية والحساسية لسياق الزمان والمكان، أي أن تتجنب العقائدية الجامدة والأصولية، فضلاً عن البراغماتية المنعدمة من المبادىء.
لقد كانت اتفاقية كامب دافيد مع نظام السادات هي أول اتفاقيات الخيانة العربية لقضية فلسطين، لكنها فشلت في فتح باب التطبيع الرسمي العربي، كما فشلت في تكريس أي تطبيع شعبي يُذكر من جانب الشعب المصري الشقيق. لذا، فإن مفتاح باب التطبيع الرسمي العربي كان – ولا يزال – فلسطينياً بامتياز! فبعد أعوام من استعمار العقول الناجح نسبياً، بات مسؤولون فلسطينيون يتحدثون بصراحة أن “المفاوضات” هي الاستراتيجيا الوحيدة للوصول إلى حقوقنا، متجاهلين حقيقة أن ما يُسمّى تفاوضاً (negotiation) مع دولة الاحتلال في هذه الظروف لا يعدو كونه نفياً (negation) متدرجاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لشرعنة ذلك بإضفاء صفة رسمية فلسطينية وعربية عليه.
هذه ليست مفاوضات حقيقية، لسببين بسيطين: أولاً، العبد لا يفاوض السيد أبداً، فإمّا أن يستجديه، وإمّا يقاومه ليصبح نداً ثم يفاوضه؛ ثانياً، المفاوضات الجدية في حالات الاستعمار المماثلة لحالتنا الفلسطينية لا تأتي إلا كجزء من استراتيجيا نضالية، وتتويجاً لتعديل موازين القوى من خلال المقاومة بمختلف أشكالها لإجبار العدو على التراجع والتسليم بحقوق الشعب الواقع تحت الاستعمار. فما بالكم والحال هنا هي لاستعمار استيطاني إحلالي يسعى لتشريد واستبدال الشعب الأصلاني برمّته، لا للتوصل إلى تسوية معه؟
لقد قطع التطبيع شوطاً مهماً، والمستوى الرسمي الفلسطيني، القوي بنفوذه الاقتصادي النسبي وأدوات قمعه والضعيف في شعبيته وشرعيته الديمقراطية، أدمن الهزيمة والتكيف معها، وهو ما أدى إلى اندماج مصالح بعض أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين مع اقتصاد الاحتلال، وإلى أن يتعامل الخطاب المهيمن مع العدو كطرف عادي، وفي كثير من الأحيان كجار صديق يوجد “بعض المشكلات” معه فقط.
بالنتيجة، أصبح بعض “القيادات” الفلسطينية “معتدلاً” إلى درجة “تقديس المدنّس وتدنيس المقدّس”، أي تقديس أوسلو والتنسيق الأمني وتقديم واجب العزاء في جنازات مجرمي الحرب الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه نُزعت “القدسية” عن القدس نفسها وعن حقوقنا الأساسية، وأهمها حق العودة، وجرى التنازل عن مواردنا الطبيعية ومنها الغاز، وبات التخاذل المريب سمة في استحقاقات محاصرة إسرائيل عالمياً من أجل فرض حظر عسكري عليها، مثلما فُرض على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل، أو في معاقبة الشركات المتورطة في جرائمها، والبعد عن استعمال الأسلحة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المتاحة، والتي يجب استخدامها للتصدي لها.
إن هذا التطبيع للعقلية الرسمية الفلسطينية أدى إلى التقليص المتدرج لأهداف النضال الوطني الفلسطيني، مثلما عبّرت عنها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، منذ تأسيس المنظمة في سنة 1964، وانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في سنة 1965 بقيادة حركة “فتح”.
فمن تحرير كامل التراب الوطني، أو تأسيس دولة ديمقراطية علمانية على كامل التراب، تحوّل الحديث إلى: الحل “المرحلي” الذي يدعو إلى تأسيس سلطة وطنية فلسطينية على أي شبر يتحرر من أرض فلسطين؛ ثم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تأكيد حق العودة للاجئين؛ فدولتين لشعبين مع تبادل أراضٍ لضمان احتفاظ إسرائيل بجميع “الكتل الاستيطانية” (ومعظم القدس المحتلة معها) وأهم الأراضي الزراعية وموارد المياه؛ وأخيراً التلميح بإمكان التنازل عن حق العودة من خلال تبنّي صيغة “العودة إلى أي مكان في الوطن” (مثلما كشفت الأوراق السرية لـ “المفاوضات”)، أو حل للاجئين “متفق عليه” مع إسرائيل، الأمر الذي يؤشر إلى “عودة” رمزية إلى الضفة وغزة فقط، وإلى التصريح بعدم الرغبة في “إغراق إسرائيل بملايين اللاجئين”، وصولاً إلى إبداء الاستعداد المبدئي للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهو ما يهدد بنسف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته.
لذا، وفي جميع حملاتها ضد موجات التطبيع الرسمي والأكاديمي والثقافي والرياضي والبيئي والنسوي والشبابي العربي – الإسرائيلي، لم تغفل حركة المقاطعة (BDS) الدور الأساسي للتطبيع الفلسطيني، وخصوصاً الرسمي، وأخطر أشكاله ما يسمى “التنسيق الأمني” و”لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”. فإذا كانت السياسة هي “فن الممكن”، فإن السياسة الرسمية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، هي فن التظاهر بعمل الممكن، بعد تقزيم الممكن، في الوقت الذي تتفادى الممكن واقعياً، بل أحيانا تُحبطه، مع أنه هو الذي من شأنه تهديد نظام الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد شعبنا وأمتنا.
وبوجود ورقة التوت الفلسطينية، وبعد أعوام من استعمار الحركة الصهيونية وإسرائيل بآلتهما الإعلامية الهائلة لعقول بعض الطغاة العرب وحاشيتهم من المثقفين ورجال الدين الزائفين، بات بعض الأنظمة الاستبدادية العربية منفتحاً على خيار خيانة قضية العرب المركزية، قضية فلسطين، في مقابل حماية عروشه الهشة، المفتقرة إلى الشرعية الشعبية.
إن معظم أنظمة الاستبداد هذه كثيراً ما اتكل على السيد الأميركي لحماية عروشه وفساده في مقابل تسهيل سيطرة الشركات العالمية، وخصوصاً الأميركية، على حصة دسمة من ثروات شعوبه. ومع التغيرات الجارية في الإدارة الأميركية، أدركت هذه الأنظمة أنها بحاجة إلى بديل يوفر لها الحماية أو يضمن لها استمرار الحماية الأميركية، وبحسب فهم هذه الأنظمة، لا يوجد مفتاح لواشنطن أهم من تل أبيب. ربما لا تستطيع إسرائيل أن تشكل بديلاً من الولايات المتحدة، لكنها الوحيدة القادرة، من خلال مجموعات اللوبي الصهيوني (بشقّيه اليهودي والمسيحي الأصولي)، على الضغط على الإدارة الأميركية لضمان استمرار حمايتها للعروش الهشة في مقابل تطبيع هذه الأنظمة مع العدو الإسرائيلي، والتنازل عن قضية فلسطين وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.
في زمن التصحر الوطني الذي نعيشه، من السهل أن نيأس لعدم قدرتنا على مواجهة الصحراء وعواصفها العاتية، لكن الواجب الوطني والأخلاقي يحثّنا على خلق “واحات” خصبة بعملنا المبدع وخططنا المدروسة وحملاتنا المبنية على رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد، بدلاً من محاولة هزيمة صحراء التطبيع والخيانة ككل. وعندما تتزايد هذه الواحات وتبدأ بالتشبيك بعضها مع بعض، تخلق واقعاً نوعياً جماعياً جديداً قادراً على صدّ الصحراء، في البداية، ثم “تخضير” أراضٍ كانت قد ابتلعتها من قبل.
إحدى هذه الواحات هي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، التي أطلقتها الأغلبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات في سنة 2005. فهذه الحركة خلقت الأرضية لتجاوز صحراء السياسة العربية الرسمية، ومنها الفلسطينية، عن طريق إيجاد مساحة للعمل الفردي والجماعي المبدع والمؤثر والقادر على المساهمة في إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى. إذاً هي استراتيجيا زراعة البذور وتنميتها انتظاراً للمناخ الملائم لقطف ثمارها.
إن حركة المقاطعة (BDS) تبدّد الانطباع الذي ساد بين كثيرين بعد توقيع اتفاق أوسلو الكارثي بأن الشعب الفلسطيني يمكن اختزاله بالفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967، من دون فلسطينيي 48 ومن دون اللاجئين. فحركة المقاطعة التي تحظى بما يقارب الإجماع الشعبي الفلسطيني في الوطن والشتات، ترفع شعار “حاصر حصارك” للراحل محمود درويش، أي عزل إسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني حقوقه المكفولة في القانون الدولي، وأهمها إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
ولا يمكن للمقاومة الفلسطينية، بما فيها حركة المقاطعة، أن تنجح من دون ربط نضالنا بصورة عضوية وتقاطعية (intersectional) بنضالات شعوب الأرض والمجتمعات المضطهدة، وخصوصاً نضالات الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية التي يحكمها القانون، والتخلص من أنظمة الاستبداد بأشكالها كافة.
فعلى الرغم من هيمنة بعض الأنظمة الخليجية الاستبدادية على معظم الإعلام ودُور النشر عربياً، ومن خطاب التيئيس والتطبيع الذي باتت هذه الأنظمة تبثّه بكثافة في الأعوام القليلة الماضية، فإن شعوب المنطقة العربية، في معظمها، لا تزال تعتبر إسرائيل عدواً رئيسياً، وتعتبر فلسطين قضيتها الأولى، وهذا وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، حتى الخليجية والأميركية منها.
لكن لا يمكن إنكار تراجع بداهة مركزية قضية فلسطين مع تراجع الوعي وتفاقم التحديات الحياتية والمطلبية للشعوب العربية. وهذا الواقع يفرض على حركة المقاطعة وشركائها حول الوطن العربي عدة تحديات أهمها ربط نضال الشعوب العربية من أجل الخبز والكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية – الاقتصادية بالنضال من أجل فلسطين، وذلك بشكل تقاطعي تقدمي، لا رومانسي ولا انتهازي.
فإسرائيل، عدا كونها عدواً مباشراً اعتدى على عدة شعوب عربية من مصر والأردن إلى لبنان وسورية وتونس والسودان والعراق، فإنها لم تجلب سوى الدمار إلى أي مكان حلّت أو ستحلّ فيه، ولم يحدث أن كانت سبباً في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتطور الحقيقي في أي بلد. ففي أميركا اللاتينية والعديد من الدول الأفريقية كرواندا وجنوب السودان وأنغولا وميانمار والهند وأذربيجان وغيرها، ساهم التغلغل الإسرائيلي، الرسمي أو من خلال الشركات، بقوة في مفاقمة الاستبداد وفرق الموت وتجارة السلاح والعسكرة والرقابة الأمنية، وملاحقة المدافعين / ات عن حقوق الإنسان والصحافيين / ات، وانتهاك حقوق المزارعين، وتحويل أولوية الإنفاق العام من البرامج الاجتماعية والخاصة بالبنية التحتية والسكن إلى الأمن والتسليح.
إن رفع الوعي التقاطعي هذا يتطلب مخاطبة قطاعات شعبية واسعة، بدءاً بالأطفال والناشئة الذين في معظمهم لا يتعلمون في مناهج دراستهم شيئاً عن فلسطين تاريخاً أو حاضراً. ومن أهم الأفكار التي تطورها حركة المقاطعة في هذا المضمار إطلاق مشروع كتابة وإصدار مجموعة قصصية لهذه الأجيال تحيي فلسطين في عقولها بأسلوب جذاب.
كذلك ثمة تحدّ مهم آخر يكمن في كيفية تحويل الدعم العربي الشعبي لقضية فلسطين ولحقوق شعبها إلى حملات مناصرة وتأثير فاعلة واستراتيجية ومستدامة وقادرة على مناهضة التطبيع الرسمي والشعبي، وفي الوقت نفسه على تحقيق انتصارات ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في انتهاكات إسرائيل لحقوقنا، وبالتالي على المساهمة في إمالة ميزان القوى إلى مصلحتنا، حتى لو كان بصورة نسبية. فمفهوم الحملات المدروسة التي تتطلب نفساً طويلاً ليس عضوياً بعد في ثقافتنا النضالية عربياً.
إن اختيار أهداف حملات المقاطعة وسحب الاستثمار يتطلب، في سياق عملنا التقاطعي عربياً، الربط بين النضال المحلي في أي بلد عربي والنضال ضد الاستعمار في فلسطين. فعلى سبيل المثال، تركَّز بعض حملات المقاطعة ضد شركات أمنية، مثل G4S، المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول، فضلاً عن دورها في إدارة مركز التدريب للشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما فيها جميع الجرائم التي ترتكبها قوات الشرطة، وضمنها قوة “حرس الحدود”.
وتتطلب المرحلة، أكثر من قبل، تعزيز مبدأ “الحساسية للسياق” الذي تنتهجه حركة المقاطعة، أي التخطيط لحملاتنا في أي موقع من خلال مراعاة خصوصيته وظروفه، لكن من دون إسقاط التمنيات أو الوصفات الجاهزة والصالحة لمواقع أُخرى مغايرة.
ففي بيان إدانة اتفاق العار بين نظام الإمارات وإسرائيل، مثلاً، والصادر عن قوى وأُطر المجتمعات العربية، ومع التركيز على حساسية موقع شعب الإمارات الشقيق الواقع تحت وطأة نظام ديكتاتوري ظالم، دَعَونا إلى الخطوات العملية التالية كي يدفع النظام الإماراتي ثمن خيانته:
1 – ندعو الشعب العربي في الإمارات إلى الاستمرار في رفض التطبيع، بما فيه الأنشطة التطبيعية التي يفخر النظام الإماراتي بتنظيمها مع الحركة الصهيونية العالمية تحت شعار “حوار الأديان”، ومقاطعة تجليات هذه الاتفاقية على الصعد كافة.
2 – ندعو الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على الأنظمة الاستبدادية والقمعية من أجل وقف علاقات التطبيع كلها مع دولة الاحتلال ومَن يمثلها، بما فيها العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونها العدو الرئيسي الذي يهدد شعوب المنطقة كافة.
3 – ندعو المواطنين / ات العرب (من غير المقيمين / ات في الإمارات) إلى مقاطعة جميع المحافل والأنشطة التي تنظَّم في الإمارات برعاية النظام، بما فيها التجارية والرياضية والثقافية والفنية والسياحية وغيرها، مثل “إكسبو دبي” المفترض عقده العام المقبل بمشاركة إسرائيلية، و”مهرجان دبي للتسوق” وغيرهما، ومقاطعة أي شركة إماراتية أو عربية أو دولية تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي.
إن أهم ما نواجه به “الجدار الحديدي” الذي بنته الحركة الصهيونية في عقول البعض منا هو موجة الأمل والعمل، أي الأمل المبني على المعرفة والعمل والمثابرة والنضال المبدئي والحكيم في آنٍ واحد حتى عودتنا وتحررنا وتقرير مصيرنا على أرضنا الحبيبة.
إن خير ما نواجه به ذلّ التطبيع هو “سحر الكرامة”.