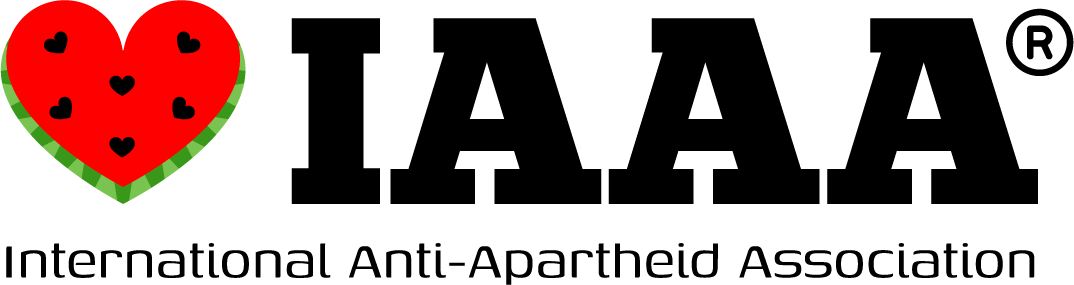مع إقامة دولة إسرائيل على إثر حرب 1948، كانت نتيجة تلك الحرب تهجير معظم أبناء الشعب الفلسطيني عن ديارهم وتحويلهم إلى مهجرين ولاجئين في بقاع الأرض المختلفة، فضلا عن الدمار الهائل الذي حل ببنية المجتمع الفلسطيني الذي كان قد حقق قبل النكبة خطى ثابتة على طريق التمدين والتحديث على مختلف أصعدة الحياة.
فقد هدم ما يزيد عن 420 قرية وخربت المراكز المدنية العامرة، ومثال على ذلك كان عدد سكان مدينة يافا قبل النكبة قرابة 95 ألفا ولم يبق منهم سوى أربعة آلاف، في حين تم تهجير جميع السكان العرب من مدن طبريا وصفد وبيسان والمجدل وأغلبية سكان حيفا وعكا واللد والرملة.
الفلسطيني مواطن إسرائيلي
لم يبق في إطار الدولة اليهودية الجديدة بعد نهاية الحرب والتوقيع على اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية التي اشتركت بالحرب (باستثناء العراق كما هو معروف) في ربيع العام 1948، سوى قرابة 156 ألف عربي فلسطيني توزعوا على أربع مناطق أساسية في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة (عكا وحيفا واللد والرملة ويافا).
وحصل أولئك أوتوماتيكيا على المواطنة الإسرائيلية، ولكنهم لم يحصلوا بطبيعة الحال على كامل الحقوق التي تمنحهم إياها تلك المواطنة، فقد فرضت عليهم السلطات الإسرائيلية نظام الحكم العسكري الذي عاشوا وطأته 18 عاما حتى إبطاله رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1966.
هذا مع العلم بأن 25% من العرب الفلسطينيين الباقين كانوا بمثابة “لاجئين في وطنهم” أي أنهم رغم البقاء في الوطن اضطروا للنزوح عن قراهم وبيوتهم التي دمرت في الحرب، والإقامة في بلدات وقرى عربية مجاورة لأماكن سكناهم السابقة.
فعلى سبيل المثال يسكن بعض سكان صفورية في الناصرة والرينة وكفر مندا وسكان الدامون وميعار في كابل وطمرة وسكان اللجون في أم الفحم وبعض سكان الطنطورة وإجزم وعين غزال في الفريديس وبعض سكان خريش في جلجولية وهكذا.
الحاضرون الغائبون
وقد صنفت هذه العينة من المواطنين العرب من وجهة نظر القانون الإسرائيلي تصنيفا غريبا على أنهم “حاضرون غائبون”، فهم حاضرون لأنهم مواطنون إسرائيليون وهم غائبون لأنهم لا يقيمون بأماكن سكناهم قبل الحرب.
وعليه تنطبق عليهم أحكام قانون أملاك الغائبين بحيث يصبح القيم على أملاك الغائبين المنتدب من قبل الحكومة الإسرائيلية مسؤولا عن التصرف بممتلكاتهم في حين يمنعون وهم أصحاب الأملاك الأصليون من التصرف بها.
هذه البقية الباقية من الشعب الفلسطيني التي تشبثت بأرضها، رغم كل ظروف النكبة وأهوالها، كانت قبل إنشاء الدولة اليهودية جزءا من الأغلبية العربية الفلسطينية التي سكنت البلاد، وعارضت تجسيد مشروع الوطن القومي اليهودي من خلال إقامة دولة يهودية في فلسطين، في حين عملت هذه الأغلبية على تجسيد الطموحات الوطنية الفلسطينية من خلال العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يمكن اعتبار هذه الحقيقة بمثابة السبب والمحرك الأساسي لتكوين الهوة العميقة الموجودة بين مؤسسات الدولة الإسرائيلية ومواطنيها العرب الفلسطينيين التي منعت حتى الآن استيعاب هؤلاء المواطنين استيعابا تاما وجعلهم شركاء حقيقيين -مع الأغلبية اليهودية- في حياة الدولة على أصعدتها المختلفة، رغم كونهم يشكلون اليوم قرابة 20% من مجموع عدد سكانها (1).
إسرائيل والتمييز بين العربي واليهودي
الفجوات بين العرب واليهود
ليس بإمكان أي شخص موضوعي أن ينكر الفجوات الواسعة الموجودة بين مجتمع الأغلبية اليهودية ومجتمع الأقلية العربية الفلسطينية من حيث مستوى الحياة، ومن حيث الإفادة من الميزانيات والمخصصات العامة، أو من حيث القدرة على الوصول إلى النخب المؤثرة على سير الأمور في الدولة.
وقد نتجت هذه الفجوات عن سياسات حكومية منهجية مميزة، وجهت بشكل مستمر ضد المواطنين العرب على أصعدة حياتهم المختلفة، وانعكست إلى حد كبير على شكل العلاقات بين الأغلبية والأقلية أو بالأحرى بين مؤسسات الدولة ومواطنيها من العرب الفلسطينيين.
تعلن إسرائيل عن نفسها بأنها دولة يهودية وديمقراطية، لكن هذا التعريف يشوبه الكثير من عدم الدقة خاصة في ما يتعلق بعلاقات الأغلبية والأقلية فيها.
يمكننا الأخذ بتعريفات بعض الباحثين الإسرائيليين الذين يتحدثون عن الديمقراطية الإسرائيلية كديمقراطية إثنية، أي أن المناخ الديمقراطي يتمتع به عنصر إثني معين (اليهودي) دون عنصر إثني آخر (العربي).
ومن المؤكد أن المواطنين العرب الفلسطينيين لا يتمتعون بشروط حياة ديمقراطية بنفس القدر الذي يتمتع به المواطنون اليهود، وإنما يعانون التمييز والتهميش ونزع الشرعية من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعابقة وعلى مدار سني الدولة الـ56.
وذلك على الأغلب إما بسبب صلاتهم الحضارية والقومية والتاريخية مع المحيط والمجال العربي العام الذي تتواجد إسرائيل في حالة حرب دائمة معه، وإما بسبب رغبة أيديولوجية راسخة لدى الحركة القومية اليهودية بتياراتها المختلفة إبقاء الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
أصعدة التمييز الستة
وفيما يلي نستعرض أصعدة التمييز الرئيسية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
يمكن تلخيص أشكال التمييز التي يعانيها المواطنون العرب في إسرائيل من خلال ستة أصعدة أساسية وهي:
أولا: السكان العرب قضية أمنية
رأي مسبق شائع في أوساط الأغلبية اليهودية يرى بأبناء الأقلية العربية الفلسطينية “قضية أمنية” ويصفهم بأنهم “طابور خامس” أو “حصان طروادة”، وعليه يجب الطعن بإخلاصهم لمؤسسات الدولة وتطبيق سياسة “المنح والمنع” للمواطنين العرب حسب مدى هذا الإخلاص.
ويعتقد المؤمنون بهذا الرأي أن على المواطنين العرب أن يتواجدوا في “امتحان الإخلاص” هذا على الدوام، ولم يسأل أي من مصممي هذا الرأي سؤالا موازيا حول مدى استعداد الأغلبية لاستيعاب الأقلية ومنحها المساواة التامة بعد أن اجتازت هذا الامتحان مرات عديدة على مدار خمسة قرون ونيّف خالية.
ثانيا: سياسة توجيه ومراقبة لصيقة
وتبرز هذه السياسة في مجالات التنظيم السياسي والنشاطات الإعلامية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن مراقبة منهجية دائمة لجهاز التربية والتعليم من حيث المضامين وآليات العمل والقوى العاملة في هذا الجهاز.
ويشترك ممثلون عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في عملية اختيار أصحاب الوظائف المهمة في جهاز التربية والتعليم، ولا يمكننا الجزم بأي حال من الأحوال بأن الاختيار يتم فقط حسب معايير مهنية بحتة تتعلق بقدرات المرشحين وحسب.
ثالثا: فرق تسد
سياسة سيادية استعلائية مرتكزة على موروث سياسي بريطاني من فترة الانتداب، مبني على مبدأ “فرّق تسد” المشهور منذ فجر التاريخ الاستعماري، بحيث يتم تقسيم أبناء الأقلية القومية العربية الفلسطينية إلى مكونات دينية طائفية (مسلمون ونصارى ودروز) أو أوساط اجتماعية (وسط بدوي وفلاحي… وهكذا).
فالسلطات الإسرائيلية وممثلوها تتحدث عن تراث درزي وتراث بدوي (وكأن ذلك يختلف عن التراث العربي)، علما بأنهم قاموا بفصل ما يسمى بجهاز التعليم الدرزي عن التعليم العربي، وهناك خطط لتنفيذ ذلك مع ما يسمى بجهاز التعليم البدوي.
رابعا: كبح الحراك الاجتماعي
وذلك بإغلاق مسارات الحراك الاجتماعي في وجه أبناء الأقلية العربية الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بالموانع الموضوعة أمام استيعابهم بالنخب المؤثرة بالمجتمع الإسرائيلي (النخب العسكرية والنخب الاقتصادية والنخب الإعلامية والنخب الثقافية).
ولا تتعدى نسبة المواطنين العرب في هذه النخب بكثير الـ1%، في حين أن نسبتهم في عدد السكان الإجمالي تصل كما قلنا سابقا إلى 20%.
وغني عن القول أن هذا البعد عن النخب المؤثرة يبعد المواطنين العرب عن القدرة على التأثير على الأجندة الإسرائيلية العامة، ويسهم الى حد كبير في عملية تهميشهم ومنعهم من التأثير حتى في القضايا التي تتعلق بجوهر كيانهم.
خامسا: التوزيع الجائر للثروة
تقسيم وتوزيع غير عادل للميزانيات والموارد على المستويين القطري والمحلي، إذ إن نسبة استثمار المكاتب الحكومية في القرى والمدن العربية ودعم المجالس البلدية والقروية فيها تعد ضئيلة للغاية إذا ما قورنت مع نسبة الاستثمار والدعم الموجهة للبلديات والمجالس المحلية والاقليمية اليهودية.
والأمر نفسه بطبيعة الحال ينطبق على مخصصات المياه للري ومخصصات معالجة وصيانة البنى التحتية إلى غير ذلك من الخدمات العامة.
فالمفاهيم السائدة في هذا المجال لدى المؤسسات والمكاتب الحكومية جاءت كما يبدو من موروث فترة الحكم العسكري الذي فرض على الأقلية العربية في الفترة الواقعة بين 1948 و1966، تلك الفترة التي أسهمت إلى حد كبير في وأد عمليات كانت قد بدأت في المجتمع الفلسطيني قبل 1948، كعمليتي التحديث والتمدين مثلا.
فوجود المواطنين تحت قوانين تعيق حركتهم وتنقلهم منع استئناف عمليات التطور وأبقى وضع الكثير من القرى العربية كما كان قبل العام 1948، من حيث البنى التحتية والخدمات العامة.
سادسا: الاستيلاء على الأراضي
سياسة منهجية مستمرة على مدار سنين طويلة للاستيلاء على الأراضي التي يملكها المواطنون العرب ومصادرتها.
وقد صادرت من خلالها السلطات الإسرائيلية مساحات واسعة من هذه الأراضي اعتمادا على قوانين ولوائح متعددة، ورثت إسرائيل بعضها من سلطات الانتداب البريطاني (قانون المصادرة من أجل الصالح العام لسنة 1943 وقانون الطوارئ لسنة 1945) أو عمدت بنفسها إلى سن بعضها الآخر (لائحة مصادرة الأراضي غير المفلوحة لسنة 1949 وقانون تسوية الأراضي لحالات الطوارئ لسنة 1949 وقانون مصادرة أملاك الغائبين لسنة 1950).
والمشترك في هذه القوانين واللوائح أنها تجيز للسلطات مصادرة الأراضي الموجودة في وضعية ملكية شخصية، لدواع أمنية أو تحت دعوى خدمة الصالح العام دون أن يكون الحق لصاحب الأرض منع هذه المصادرة.
وعليه فإن مساحات واسعة من الأراضي التابعة للمواطنين العرب قد تمت مصادرتها بهذه الطريقة وتحت ستار هذه القوانين، وعليه فقد تناقصت مساحات الأراضي التي يملكها العرب بشكل دائم إلى درجة أن مجموع ما يملكه المواطنون العرب اليوم لا يتعدى 2.5% من مجموع ما يملكه المواطنون في الدولة.
وباستطاعتنا القول إن موضوع الأراضي كان نواة أي صدام حصل بين السلطات الإسرائيلية ومواطنيها العرب، فقد كان معظم الصدامات الدامية التي حصلت بين متظاهرين عرب وقوات الشرطة الإسرائيلية على خلفية هذه المصادرات.
ومثال ذلك ما حصل في يوم الأرض 30 مارس/ آذار 1976 ومصادمات أراضي الروحة في خريف 1998 ومصادمات أم السحالي عام 1999 وهكذا.
بل إن التنظيم السياسي الأول للعرب الفلسطينيين في إسرائيل الذي تصادم مع السلطات الإسرائيلية وأخرج عن القانون (في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي) كان تنظيما حمل اسم “الأرض” ويمكننا الافتراض بأن ذلك لم يكن من قبيل الصدفة.
“
يجب على مصممي الرأي العام الإسرائيلي نزع شرعية الحديث والتداول حول إمكانية الترحيل “الترانسفير” للمواطنين العرب
“
والسؤال هو إذا كان بالإمكان تغيير أجواء العلاقات بين الأغلبية والأقلية والسير على طريق استيعاب المواطنين العرب في أصعدة الحياة المختلفة في الدولة ومنحهم المساواة التامة، وهو يتعلق بالدرجة الأولى بالنوايا الحسنة لدى مجموعة الأغلبية.
من الجدير بنا أن نؤكد هنا أن أي تغيير جذري على شكل هذه العلاقات مقرون أساسا بإيجاد تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأن الاستمرار بهذا النزاع وأي ارتفاع بمستوى حدته سيعرقل أي تغيير أو تحسن جدي بشكل هذه العلاقات.
هذا مع العلم بأن هناك جملة من الخطوات التي يترتب القيام بها يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
- معالجة جدية لموضوع “الحاضرين الغائبين”، وهي مكانة قانونية من النادر أن نجد لها مثيلا في العصر الحديث (خاصة لدى الدول التي تعرف نفسها على أنها دول ديمقراطية)، فالمجموعة التي ينطبق عليها التعريف وتشكل 25% من مجموع المواطنين العرب، كما أسلفنا أعلاه، اقاموا جمعيات ولجانا تنطق باسمهم، وتؤكد هذه الجمعيات أن قضيتهم يجب أن تجد حلا لها بمفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، بشكل يجعل منهم مواطنين تامين بما في ذلك قدرتهم على التصرف بحرية بأملاكهم التي صودرت على أثر تهجيرهم أثناء حرب 1948.
- إرجاع أموال وأراضي وعقارات الوقف الإسلامي لملكية الطائفة الإسلامية، وهي الطائفة الدينية الوحيدة في إسرائيل التي لا تستطيع التصرف بأملاكها الموضوعة منذ العام 1948 تحت تصرف القيّم على أملاك الغائبين.
- الاعتراف بمجموعة القرى غير المعترف بها والمعروفة باسم “قرى الأربعين”، ومنحها المكانة القانونية التي ستسمح بربطها بشبكات البنى التحتية من شوارع وماء وكهرباء التي حرمت منها حتى الآن، وذلك لكونها لم تفز باعتراف رسمي من السلطات الإسرائيلية حتى اليوم (2).
- تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية القاضي بإرجاع مهجري قريتي أقرت وبرعم اللتين كان سكانهما فد أخرجوا منهما من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء حرب 1948 على أن يعودوا إليهما بعد مدة وجيزة، وقد طالت هذه المدة ولم تنته حتى أيامنا هذه، رغم إقرار القضاء الإسرائيلي بضرورة إعادتهم الفورية إلى أراضيهم.
بالإضافة للخطوات العملية الأربع المذكورة أعلاه، من الضروري أن ترافق هذه الخطوات بعض الخطوات الإعلامية التوضيحية المتعلقة بإجراء تغييرات جذرية بالرأي العام بهدف تغيير المفاهيم السائدة بالرأي العام الإسرائيلي تجاه الأقلية القومية العربية في إسرائيل التي تمت صياغتها في سنوات دولة إسرائيل الأولى وهي ما زالت ترى بأبناء هذه الأقلية “قضية أمنية” وخطرا محدقا يهدد أمنها.
ولعل الخطوة الأبرز التي يجب على مصممي الرأي العام الإسرائيلي اتخاذها هي نزع شرعية الحديث والتداول حول إمكانية الترحيل “الترانسفير” للمواطنين العرب، تلك الفكرة التي انتشر تداولها في وسائل الإعلام وبعض الأوساط السياسية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.